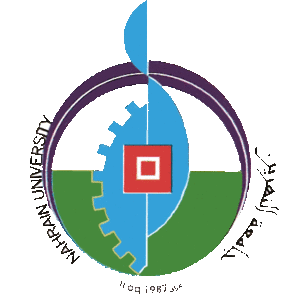أن أغلب الأنظمة القانونية, إن لم نقل أجمعها, قد وصفت بأنها الأكمل أو الأكثر صلاحاً وإستجابة لحاجات الإنسان بل عين هذا الأمر نجده متحققاً في مجمل الفكرالإنساني بمذاهبهِ الفلسفية العامة وإتجاهاته الفردية وصولاً للتجارب الشخصية لبعض المفكرين.(2) فنرى أصحاب هذا المنهج أو ذاك يرون الكمال والإبداع فيه دون غيره وعملياً يلاحظ إن إناطة التنظييم لجانب معين من جوانب الحياة بالقانون ونزول الأخير لمرحلة التطبيق, يجعل ذلك الوصف في موضع إختبار واقعي موضوعي, حيث تتبدى في التطبيق الأوجه السلبية والإيجابية للقانون فتتحدد في مدار ذلك فكرة نجاحه ومدى قدرته على الإستجابة لواقع الحياة وطبيعة العلاقات الإجتماعية والعناصر المؤثرة فيها ويصل تأثير المنظومة القانونية لأُسس الكيان الفكري والحضاري لمجتمع معين ولعل واقعنا الإسلامي والعربي منه خصوصاً لَيُقَدِم أوضح مصداق لهذا الطرح, إذ أنه (2) شهد ولادة شتى المذاهب الفكرية التي تدعو لتبني منهجية معينة في مختلف جوانب النشاط الإنساني فإمتزجت العناصر العملية للواقع الإقتصادي بالعناصر السياسية في بوتقة الحياة الإجتماعية ومعطياتها وإكتسى ذلك التمازج طابعاً جدلياً قاد إلى إنبثاق دعوات, ترى ضرورة تبني الأنظمة القانونية الغربية بإعتبارها, وفق رؤية البعض, العلاج الناجع للواقع الإسلامي وإنها الأقدر على النهوض بأوضاعه وهذا التوجه في الحقيقة ينطوي على خطأ كبير لإغفاله إن هذه المشكلة العملية تعيشها ذات الأنظمة القانونية الغربية, فحدود الحرية مثلاً, في جملة من الدول الرأسمالية, وصلت إلى مطالبة العديد من الأفراد بوجوب إباحة القانون للزواج المثلي فوضع مفهوم الحرية أمام جزئية توجب إعادة النظر في مفهومه أو على الأقل في حدوده بالإضافة لذلك فإن الدعوة إلى تبني الأنظمة الغربية يعني ذر المنهج الإسلامي بكل أبعاده العامة المتمثلة, برؤيته للحياة والإنسان, وأبعاده ُالخاصة المتجلية في جهود فقهاء المذاهب الإسلامية وباحثيها المحدثين, والتي ينبغي أن تعبر عن تلك الرؤية العامة, لأن الإخفاق أو التعثر العملي للنصوص الجزئية الحاكمة للتصرفات وثلة من الوقائع, يؤشر سلباً, عدم موضوعية الفكرة العامة التي تدور في فلكها النصوص الجزئية, أو إن الأخيرة تعكس إخفاقاً تشريعياً تمثل في صياغة نصوص لاتستجيب لتلك الرؤية العامة.