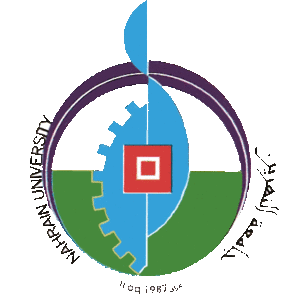لقد أشرت فصول التاريخ السياسي الدولي وانعطافاته، حقيقة ابتدائية مفادها ان البشر شعوباً وأمم، دولاً وإمبراطوريات، كانوا، ومازالوا مجبولين، لحد هذه اللحظة، على فطرة السعي الممزوج بالأمل والتضحية، لبلورة إرادة جمعية تلمّهم برغم تنوع محاولات الإفصاح عن صورتها لديهم، نظرياً وعملياً. فالذات الجمعية، وكما أثبتت ذلك أدبيات العلوم الاجتماعية ومنها علم السياسة، بدت تمثل هدفاً وغاية، وعنواناً للوجود الأزلي للبشر. فبدونها لم تستقم أحوال العالم ولم تضبط نظمية وجوده، طالما بدا الكون منظومة محددة الوجود والأداء. وبرغم تنوع أساليب الإفصاح عن تلك الذات التواقٌة للتغيير دوماً، فإن الشعوب والأمم، اشتركت عقلاً ووجداناً في تأطيرها في معطى أساس، لم تتجاوزه العصور والدهور، ولم تنل منه التحديات، ذلك المعطى هو الدولة.. الوطن والهوية والاستحقاق. فالدولة القومية، وإن مثلت بولادتها حاضنة اجتماعية للوجود البشري، إلا إنها، بذات الوقت، مثلت انجازاً (نتاجاً) تاريخياً، ارتفعت عبره الشعوب والأمم إلى مستوى من التطور في رؤيتها لذاتها وعنونتها. ولم يكن ذلك الارتفاع أو (المدرك المنشئ) أو (الإرادة المشتركة) أو (المشيئة الجمعية)، ليحصل لولا منازعة الشعوب لذاتها، تبدلاً وتحولاً وتغييراً، حتى أصبحت الدولة عنواناً لا لتغيير الحال، بل عنواناً للتغيير الذي لاح المدرك الجمعي للشعوب التي تمكنت من إدارته بالمنطق وربما بالفطرة المنشئة للوجود. بدليل ما بدت عليه الدولة كنسغ تاريخي الولادة والفعل، برغم تدخل الفلسفة والفكر عموماً في بلورته كغاية نهائية أو كهدف مؤقت كما هو الحال عند الماركسية. وهكذا بدت الدولة القومية، ولادة وبناءاً، تطوراً وشموخاً وعمقاً، صنو التغيير. فيا ترى كيف بدا ذلك؟ وما هي مظاهر العلاقة بين الدولة كمعطى والتغيير كظاهرة؟ هذا ما التمسه الباحث في تبرير اختياره لموضوع دراسته ابتداءً. لم يكن هدفنا استرجاع البعد التاريخي في نشأة الدولة، فذلك ما سنفصح عنه في ثنايا دراستنا، بل جل قصدنا، ابتداءً، تقديم مقتربات فهم للمبادلة أعلاه. فعلى الرغم من التسليم بثبات الدولة، كمعطى، وما جسدته من حقائق ووقائع تاريخية، إلا أن ذلك لا يمنع من خضوعها للتغيير ذاتياً، حيث توسع أعمالها ونشاطاتها وتطور وسائلها وأهدافها والذي فرض عليها تحديد استجابات متنوعة، القصد منها الحفاظ على كينونة وجودها والاستدلال عليه، وموضوعياً حيث خضوعها للآخر، سلوكاً وأهدافاً. فثبات حياض (إقليم) الدولة، وإن جاء عن طريق إدراكها لما ينبغي أن تكون عليه، تاريخياً وبايولوجياً وإمكانات (قوة وقدرة)، إلا إنه غالباً ما يتعرض إلى أطماع دول أخرى تبحث عن تجسيد إرادتها الجمعية حتى لو على حساب الدول الأخرى، استنباتاً لمظاهر التغيير أو ركوباً لموجاته، تلك الأطماع التي لم تستطع أية حدود قانونية كانت أم أخلاقية من ترويضها على مدى تاريخ النظام الدولي، حتى بدت فصوله وكأنها صراعية مربوطة على التغيير بامتياز.والحقيقة، إن الأطماع والنوايا بالتوسع لدى دول بعينها ومن خلفها شعوبها المتعطشة لإثبات ذاتها (شواهد التغيير)، خلقت وقائع متواترة جعلت من فكرة بناء الدولة مادة نقاش مهمة. لذا لا يخطئ من يربط تاريخ الدولة بتاريخ الفلسفة والحق والمعرفة (حواضن التغيير ومسوغاته)، وهو ما جعل البحث في الدولة ذا حيوية بالغة لم تثلمها تطورات التاريخ ولا تحدياته المتواترة، التي ما أن تحل بدولة ما حتى تزوغ الأبصار إلى ضرورة مراجعة الظاهرة المنشئة لها. كما هو الحال مع ما يعانيه العالم من تواتر مصطلحات الدولة المنهارة أو الدولة الفاشلة، أو ما تعانيه الدولة القومية من تفتيت وتجزئة وانفصال. وعلى الرغم مما أحدثته حركة التغيير الدولية وموجتها الأخيرة بعد عام 1985، حيث دعوة غورباتشوف (البرويسترويكا) لإعادة تقويم الأداء الإستراتيجي السوفيتي، التي عمقت من هول تغيير وعصف أحداث ووقائع لاحت هيكلية النظام الدولي ومن ثم بناه الأدائية، فإن انعكاساتها كانت موجهة أساساً نحو الدولة القومية، فجعلتها مادة لها وساحة لما ترغب القوى الدولية المتحكمة لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية تجريبه عبر خطط إستراتيجية، وخرائط طريق أدائية، ومشاريع لإعادة تشكيل الدولة القومية من جديد، كانت حصيلتها، تعثر الدولة القومية أساساً في القبض على استجابة محددة ومنقذة لما تمر به من ارتباك وحيرة فكرية وأدائية، أماتت الجذوة التي كانت الدولة القومية تمسك بها إبان القطبية الثنائية، لرؤية ذاتها فاعلاً أساسياً في النظام الدولي، ولتغدو عرضة بل ضحية لاستجابات، جلٌها كانت مقننة لإدارة التغيير لصالح القوى الدولية الكبرى. وقد كان من جراء ذلك، سيما في ظل ما أمتاز به النظام الدولي من سيولة أداء جعلته أقرب للوضع منه إلى نظام، إن بدت الدولة القومية غير قادرة على لملمة وجودها وتثبيت مكانتها الإستراتيجية والتاريخية خاصة في ظل تنامي تأثير وحدات دولية جديدة. لتضع التغييرات الدولية، الدولة القومية أمام نتائج خطيرة حملتها صور التأثر التي تعرضت لها بناها وأداء السلطة فيها، وارتباك صناع القرار لديها فضلاً عن تراجع مكانتها الإستراتيجية وتبدل أدوات الاقتراب لما ترغب به من أمن، فضلاً عن تغيير وظائف ما تحلم وتسعى إليه من أدوار، إقليمياً ودولياً.وفي خضم ذلك، كانت الدولة القومية ومنذ عام 1991، حيث نهاية الحرب الباردة، ولم تزل، أمام استحقاق تاريخي عبرت عنه محنتها في ظل ما تمر به من تحديات متسارعة التواتر وصلدة الأثر، لتبدو أمام خيارين أما التسليم بانهيارها وفشلها في المحافظة على الإرادة/ المشيئة، المنشئة لها والمؤطرة لوجودها، أو إعادة اكتشاف الإرادة، إصلاحاً، أو تكوناً من جديد، وكلا الخيارين مربوط على حتمية توافر إستراتيجية أداء/ إدارة لتلك الإرادة التي كانت ولم تزل كلية الوجود أو الاكتشاف من جديد. وهذا ما أثقل كاهل الدولة القومية وهي تبحث عن سر تلك الإستراتيجية، لذا تراها وقد تعددت التماساتها المركبة للوصول إلى حاجة التشبث بها. وهذا ما تحققنا منه فرضيةً واستنتاجاً.