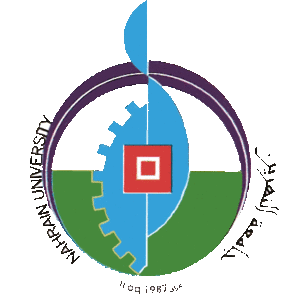إنَّ ظاهرة التدخل الإنسانيّ ليست جديدة في العلاقات الدوليّة، لكنها أصبحت بارزة بصورة رئيسة في عالم ما بعد الحرب الباردة، فقد عملت التحولات التي شهدها النظام الدوليّ أثر انهيار منظومة الدول الاشتراكية، وتفكك الاتحاد السوفيتيّ، وانتشار الصراعات الداخلية في كثيرٍ من الدول، على إبراز شكل جديد من التدخل، يتم تحت مسوّغ الدفاع عن حقوق الإنسان، وحماية الأقليات، وتقديم المساعدات الإنسانيّة، ولاسيما أنَّ منظومة الدول الرأسمالية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على نشر القيم الليبرالية وحمايتها، بوصفها أكثر القيم قدرة ًعلى صون مصالحها الوطنية وتحقيقها في عهد ما بعد الحرب الباردة؛ لذلك ازدادت حالات التدخل الدوليّ تحت ما سُمِّيَ (التدخل الإنسانيّ) كمدخل لتغيير القواعد القانونية الدوليّة التي أفرزها نظام القطبية الثنائية في ضوء إيجاد السوابق التي تمهد لتغيير تلك القواعد القانونية، بما يتماشى والقدرات المادية والمصالح الوطنية للدول العالمية، في حين أنَّ الدول النامية التي هي موضع التدخلات الإنسانيّة ما زالت تتمسك بالقواعد القانونية التي تُعّد التدخل العسكريّ عملاً غير مشروع. ومن هنا تبرز أهمية تحليل هذه الظاهرة الدوليّة، نظراً إلى خطورة الآثار السياسية القانونية المترتبة عليها فيما يخصُّ مبادئ القانون الدوليّ، ولاسيما مبدأ السيادة، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهم المبدآن اللذان يحكمان العلاقات بين الدول المستقلة التي تُعّد ابرز وحدات النظام الدوليّ، على وفق ميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد أنَّ التدخل بالقوة المسلحة في الشؤون الداخلية للدولة يتعارض مع القانون الدوليّ، وأسس الشرعية الدوليّة، على الرغم من كلَّ ما يرافقها من مسوغات . وهذا يعني أنَّ قبول التدخل الإنسانيّ على أساس أنَّه قاعدة قانونية دولية، يجب أنْ يتم بعد ضبطه قانونيًا وسياسيًا، حتى ينتهي الاستعمال ألذرائعي له، في ظلِّ معايير محددة، تلقى إجماعاُ دولياً، لأنَّه في ظلٍّ نظام دوليّ، لا توجد فيه سلطة مركزية تقدر على النظر في سلوك الدول بصورة مجردة وبمعيار واحد، ومع وجود تفاوت في القدرات المادية، واختلاف في المصالح الوطنية، فإنَّ ذلك يتيح استعمال هذه القاعدة بنحوٍ انتقائي ومزدوج المعايير على وفق عوامل سياسية واقتصادية، من دون النظر إلى الظروف الإنسانيّة، ولاسيما وأنَّ القيم النبيلة في ظلِّ علاقات القوة والمصلحة تجعل التدخل الإنسانيّ؛ يستعمل لمصلحة الأقوياء، وضد الضعفاء، عند انتفاء مسوغات أخرى لاستعمال القوة. ومن ناحية أًخرى لم يعد الفرد مجرد غاية القانون الدوليّ، و إنما أصبح أحد رعاياه، فقد بدأت ظاهرة تدويل حقوق الإنسان منذ إنشاء منظمة الأمم المتحدة، وصوغ الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان ، وإبرام كثير من الاتفاقيات الدوليّة ذات العلاقة، وعلى رغم من ذلك لا تزال الحماية الدوليّة لحقوق الإنسان ضعيفة، لعدم توافر سلطة دولية مركزية، تتولى تنفيذ تلك الاتفاقيات، إذ ترك لكلِّ دولة حرية تنفيذ التزاماتها الدوليّة في نطاق سيادتها الوطنية، لكن الربط الوثيق بين احترام حقوق الإنسان وضمان السلم والأمن الدوليّين، أخرج مسألة حقوق الإنسان من نطاق الاختصاص الداخليّ إلى نطاق الاختصاص الدوليّ، ولاسيما بعد أن تنازلت الدولة عن وظائفها في عددٍ من المجالات، نتيجة التداخل و التشابك بين الدول، والاعتماد المتبادل لتحقيق المنافع والمصالح المشتركة، فأدى ذلك إلى تآكل سيادة الدولة الداخلية، وسيادتها الخارجية وغيّر طبيعة علاقة الفرد بدولته . ويدلُّ هذا التطور على أنَّ مسالة حقوق الإنسان لم تُعّد ضمن الاختصاص الداخليّ للدولة، ولاسيما أنَّ عوامل الاعتماد المتبادل بين الدول، وتطور التضامن الدوليّ فرضت على الدول والمنظمات الدوليّة مراقبة ما يجري داخل أية دولة، وتقديم المساعدة الإنسانيّة لضحايا الكوارث الطبيعية والحالات الإنسانيّة المماثلة، منها: انتهاك حقوق الإنسان في عددٍ من الدول، ولاسيما حماية حقوق الأقليات من الاضطهاد إذ لم تُعّد السيادة مسوغاً لانتهاك حقوق الإنسان الأساسية، ولاسيما أنَّ الدولة ملتزمة في ممارستها لمظاهر سيادتها بالقانون الدوليّ، وما يتضمنه من التزامات تفرض عليها احترام حقوق الإنسان وكرامته، وهو أمر يثير الجدل القانوني والسياسيّ حول حدود العلاقة بين الاختصاص الداخليّ والدوليّ في ظلِّ زيادة التداخل بينهما .